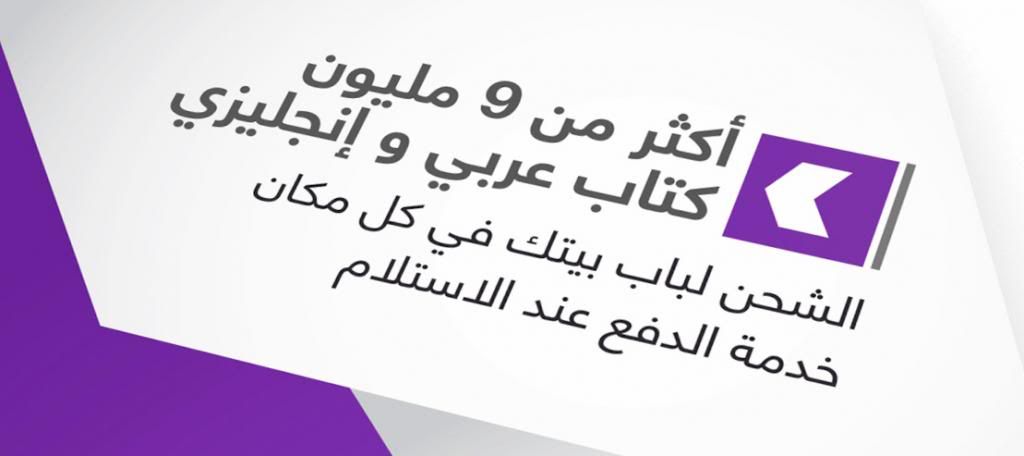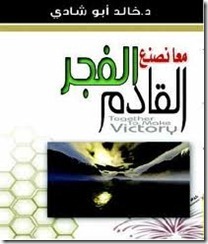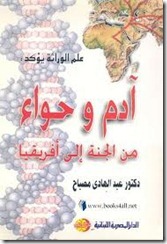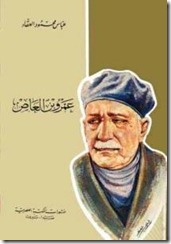عبارة عن نقد إسلامي للتفسيرات الوضعية للتاريخ ؛ المثالية والمادية والحضارية عند هيجل وماركس وتوينبي ، ومقابلتها بما يسميه المؤلف " الواقعية التاريخية " في القرآن الكريم .
وكتاب الدكتور عماد الدين - أستاذ التاريخ الاسلامي في جامعة الموصل - قديم نسبيا ، إذ صدرت طبعته الأولى عام 1975م إبان مناهضة الشيوعية والاشتراكية في المقام الأول ، وطبعته في الرابط المرفق أدناه هي الخامسة ، وصدرت عام 1991 م .
يتميز الموقف الإسلامي من التاريخ بمرونته وبعده عن التوتر أو التأزم المذهبي الذي يسعى إلى قولبة الوقائع التاريخية، وصبّها في هيكله المسبق، واستبعاد أو تزييف كل ما لا ينسجم وهذا الهيكل، الأمر الذي يوقع التفاسير الوضعية في كثير من الأخطاء والانحرافات. هذا إلى جانب أن الفكر الوضعي لا بد وأن يتأثر بطبيعة العصر الذي يعيشه سلبًا وإيجابًا، وبدرجة أو أخرى، وهذا (التأثير) المحتوم ينعكس -ولا ريب- على معطياته الفكرية، سواء كانت (صيغة) هذا التأثر بشكل (تقبّل) لقيم العصر وأوضاعه ومناهجه ورؤاه، أو (رفض) لها وتمرّد عليها. ففي كلتا الحالتين يلعب الجانب التأثري الانفعالي، والإسقاطات الظاهرة والخفية، في "الوعي" و"اللا وعي"، دوره في الرؤية التي يمارسها المفكر تجاه الأوضاع والأحداث والأشياء.
فإذا ما حدث وكان المفكر مفسرًا للتاريخ، وتفسير التاريخ -كما نعلم- توسيع للتحليل صوب الماضي والمستقبل اللذين يندّان كثيرًا عن الحصر والضبط والتحديد، فإن لنا أن نتصور كم سيجيء هذا التفسير مطبوعًا بطابع العصر الذي يعيشه المفسر، وكيف أن الأشياء والظواهر والأحداث، في الماضي والمستقبل، ستأخذ اللون الذي يجد المفسر نفسه مضطرًّا إلى النظر من خلال زجاجته التي أسقطت عليها مواضعات العصر الظلال والأضواء. وهذا يؤدي إلى أن تبعد التفاسير الوضعية، بدرجة أو أخرى، عن العلمية والموضوعية والحياد.
أما التفسير الإسلامي، الذي يستمد من رؤية الله التي تعلو على الزمان والمكان، وتتجاوز مواضعات العصر النسبية، فإنه ينظر بانفتاح تام إلى الأحداث، ويسلّط الأضواء على مساحاتها جميعًا، دون أن يقتصر على الأحمر أو الأخضر لكي تبدو حمراء أو خضراء.. وهكذا فإن ثمة فرقًا (منهجيًّا) حاسمًا بين المذاهب الوضعية وبين المذهب الإسلامي في تفسير التاريخ.. في الأولى تُصاغ حقائق التاريخ، أو يُعاد عرضها، وفق المذهب (المصنوع) سلفًا فتفسر على الانسجام مع وضعية المذهب، وتُساق للتدليل عليه وتأكيده، وهذا الخطأ يجيء من حقيقة أن وقائع التاريخ سبقت في الزمن تخطيط المذاهب.
ومن ثَمَّ فإن المذاهب جاءت كقضية (بعدية) تسعى إلى أن تجبر (القبليات) على التشكل بها. وهذا التأزم المذهبي، هذا التحديد الصارم للنظم التي تتبعها الوقائع التاريخية في مسارها، هذا التوتر في التزام هيكل نظري مسبق، تُساق أحداث التاريخ للتدليل عليه بالحق والباطل، والذي بلغ أقصى حدته في المادية التاريخية التي رسمها (ماركس وانغلز)، مما دفع عددًا من المفكرين الأوربيين إلى اتخاذ موقف معاكس تمامًا، يمثل رد فعل إزاء الموقف السالف، بحيث إنهم رفضوا القول بخضوع الحركة التاريخية لأي ناموس أو سنة، ومسيرتها وفق أي نظام مهما كان. وقد بلغ هذا الموقف، غير الموضوعي هو الآخر، أقصى حدته على يد (كارل بوبر) في كتابه المعروف (عقم المذهب التاريخي).