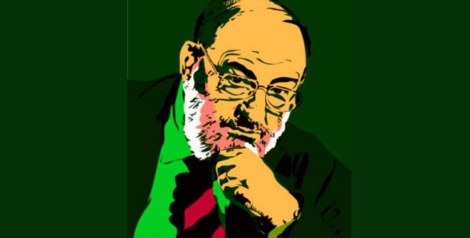مستقبل الكتاب.. أومبرتو إيكو
من اختراع الكتابة للكمبيوتر.. مستقبل الكتاب
ترجمة: ياسر شعبان
منذ وصولي ندوة حول مستقبل الكتاب توقعت أن يستشهد أحدهم بهذه العبارة Ceci Tuera cela وقد دفعني إلى ذلك كل من “دوجويد” و”ننبرج”، فهي عبارة ذات صلة بموضوعنا.
ودون شك هي العبارة نفسها التي قالها “فرولو”، في رواية “أحدب نوتردام” لـ”فيكتور هوجو”، وهو يقارن الكتاب بالكاتدرائية القديمة (الكتاب سوف يقتل الكاتدرائية، الأبجدية سوف تقتل الصور). وهي نفس العبارة التي استخدمها “ماكلوهان” وهو يقارن حانةً للرقص في ولاية مانهاتن بمجرة جوتنبرج.
نعرف ما يكفي عن الكتاب، ولكن ما نعنيه بالكمبيوتر هو الأمر غير المؤكد. هل هو أداة يمكن بواسطتها توفير مزيد من الاتصال باستخدام الأيقونات؟ أم هو أداة يمكنك الكتابة عليها والقراءة منها دون الحاجة إلى أدوات مثل الورق؟ أم هو وسيلة لن يسمع بعدها عن خبرات النص المكتظ بالألفاظ؟
لا يُعد أي من هذه التعريفات كافيًا لتعريف الكمبيوتر، لما يلي:
أولًا: يُعتبر الاتصال المرئي أكثر انتشارًا في التليفزيون ودور العرض، مقارنةً بالكمبيوتر والذي يُعد أداة أبجدية بشكل واضح.
ثانيًا: وكما يقول “ننبرج”، فإن الكمبيوتر يقدم أشكالًا جديدة للإنتاج وانتشار الوثائق المطبوعة.
وثالثًا: وكما يذكر “سيمون”، فإن نوعًا من تجارب النص المتشعب/ المتعدد (على الأقل من منظور النص الذي لا يستلزم قراءته بطريقه خطية وكرسالة تامة) تواجد في فترات تاريخية أُخرى، و”جويس” (الحي) موجود ليثبت أن “جويس” (الراحل والباقي دائمًا) قَدّم لنا في” Finnegans wake صحوة فينيجانز” مثالًا جيدًا للنص المتشعب.
إن فكرة أن شيئًا سيقتل شيئًا آخر هي فكرة قديمة للغاية، ومن المؤكد أنها ظهرت قبل “هوجو” وقبل مخاوف “فرولو” في العصور الوسطى المتأخرة. وطبقًا لأفلاطون (في فيدروس)[1]، فإن تحوت/ توت أو (هرمس حسب اليونانيين)، المخترع المزعوم للكتابة، قدم اختراعه للفرعون “تحتمس” الذي سوف يسمح للإنسان بأن يتذكر ما كان لينساه بدونه، لكن الفرعون لم يرض عن ذلك وقال: إن الذاكرة هي أعظم هبة يجب الحفاظ عليها حية بالتدريب المستمر، وباختراعك الجديد لن يكون على الإنسان تدريبها لأنه سوف يتذكر الأشياء ليس عن طريق جهد داخلي لكن بواسطة وسيلة خارجية.
ويمكننا أن ندرك قلق الفرعون. فالكتابة، مثل أي وسيلة تكنولوجية حديثة، من شأنها أن تخدر القوة البشرية التي حلت محلها، تمامًا مثلما جعلتنا السيارات أقل قدرة على السير.
كانت الكتابة اختراعًا خطيرًا لأنها حَدّت من قدرات العقل عن طريق تزويد الإنسان بروح متحجرة، وعقل مُشوه وذاكرة تذبل مثل النبات.
بطبيعة الحال كان نص أفلاطون نصًا ساخرًا، وقد كان أفلاطون يدون حجته ضد الكتابة ولكنه كان يتظاهر أن خطابه يرويه سقراط الذي لم يكتب (فمن الناحية الأكاديمية يبدو جليًا أنه اندثر لأنه لم ينشر أعماله) لذلك فقد كان سقراط يعبر عن مخاوف عصره. إن أمرًا داخليًا والمفكر الحقيقي لن يسمح للكتاب أن يفكر بدلًا منه.
ولا يوجد من تساوره هذه المخاوف في الوقت الحاضر وذلك لسببين بسيطين:
الأول: معرفتنا بأن الكتاب ليس الوسيلة التي تجعل شخصًا آخر يفكر بدلًا منا، فعلى العكس من ذلك فإن الكتاب وسيلة لاستثارة الفكر بشكل أكبر، فبعد اختراع الكتابة أصبح من الممكن كتابة عمل رائع عن الذاكرة الفطرية مثل “البحث عن الزمن المفقود” لـ”بروست”.
ثانيًا: إذا ما احتاج الإنسان ذات يوم لتدريب ذاكرته ليتذكر الأشياء، فبعد اختراع الكتابة عليه أن يدرب ذاكرته ليتذكر الكتاب، فالكتاب يمثل تحديًا ويعمل على تحسين الذاكرة حتى لا تضعف.
وعلى المرء أن يتأمل هذا الجدل القديم في كل مرة يقابل فيها وسيلة اتصال جديدة تبدو أنها ستحل محل الكتاب.
الصور مقابل الثقافة الحرفية
لا تُعتبر ثقافتنا المعاصرة ذات وجهة صورية، ولنأخذ على سبيل المثال ثقافة اليونان آو العصور الوسطى، ففي هذه العصور اقتصرت معرفة القراءة والكتابة على الصفوة المختارة، بينما كان يتم تعليم وتثقيف وإقناع الشعب (دينيًا – سياسيًا وأخلاقيًا) عن طريق الصور، ويستشهد “بولتر” أنه حاليًا في الولايات المتحدة يتم تقديم خليط متوازن من الحروف والأيقونات إذا ما قارناها مع “Bilblia Pauperum- الكتاب المقدس المصور”[2] يمكن أن نشكو من أن كثيرًا من الناس يقضون يومهم في مشاهدة التلفزيون ولا يقرؤون كتابًا أو جريدةً أبدًا، وهذه بالتأكيد مشكلة اجتماعية وتعليمية ولكننا عادة ما ننسى أن نفس هؤلاء الناس منذ قرون قليلة مضت كانوا يشاهدون على الأكثر مجموعه محدودة من الصور، وكانوا أميين تمامًا.
وعادة ما يتم تضلينا بواسطة وسائل الإعلام التي تنتقد بصورة منتظمة وسائل الإعلام الأخرى التي تتسم بالسطحية والتأخر، في حين أنه ما زالت وسائل الإعلام تكرر أن الفترة التاريخية التي نعيشها تسيطر عليها الصور بشكل متزايد، وهذه هي أول مغالطات “ماكلوهان”، وقد قرأ القائمون على وسائل الإعلام كتابات “ماكلوهان” متأخرًا، وسيكون الجيل الحالي والجيل القادم أكثر ميلًا للحاسب الآلي. وتعتبر أهم سمة لشاشة الكمبيوتر أنها تضم وتعرض عددًا أكبر من الحروف الأبجدية أكثر من الصور، لذا فسيكون الجيل الجديد جيلًا أبجديًا ولن يكون له ميول لاستخدام الصور، وسنعود مرة أخرى لمجرة “جوتنبرج” وأنا على يقين أنه لو كان “ماكلوهان” قد عاش حتى اندفاع التفاحة إلي “وادي سليسون” كان سيعترف بهذا الحدث الهائل.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن الجيل الجديد مدرب على القراءة بسرعة هائلة، لذلك فإن أستاذ الجامعة من النمط القديم غير قادر اليوم على قراءه شاشة الكمبيوتر بنفس سرعة المراهق. فهؤلاء المراهقون إذا ما أرادوا بالصدفة برمجة الكمبيوتر في منزلهم لابد أن يعرفوا أو يتعلموا الإجراءات المنطقية والحسابية، ويجب عليهم كتابة الكلمات والأرقام على لوحة المفاتيح بسرعة هائلة.
أثناء فتره ثمانينيات القرن العشرين، نُشرت في الولايات المتحدة بعض التقارير القلقة والمثيرة للقلق؛ مُنبهة إلى انحدار مستوى معرفة القراءة والكتابة. وقد كان أحد الأسباب وراء الانهيار المفاجئ في وول ستريت (الذي أنهى عهد ريجان)؛ طبقًا للعديد من المراقبين؛ ليست فقط الثقة الزائدة في الكمبيوتر، ولكن أيضًا حقيقة أن الشباب المستهتر الذين كانوا يتحكمون في سوق المال (البورصة) حينها لم يكونوا على دراية كافية بأزمة عام 1929، لم يكونوا قادرين على التعامل مع الأزمة، حيث كانوا يفتقرون للخلفية التاريخية. وهكذا لو كانوا قرأوا بعض الكتب عن يوم الخميس الأسود لكانوا قادرين على اتخاذ قرارات أفضل لتجنب الأخطار المعروفة.
لكنني أتساءل ما إذا كانت الكتب هي الوسيلة الوحيدة الموثوق بها لاكتساب المعلومات. منذ سنين كانت الوسيلة الوحيدة لتعلم لغة أجنبية، غير السفر للخارج، هي دراسة اللغة من الكتاب. والآن عادة ما يتعلم أطفالنا اللغات الأخرى عن طريق سماع التسجيلات، مشاهدة الأفلام في لغتها الأصلية، أو عن طريق فك شفرة التعليمات المطبوعة على علب المشروبات. نفس الشيء يحدث مع المعلومات التاريخية، ففي طفولتي اكتسبت أفضل المعلومات عن البلاد الغريبة ليس من الكتب ولكن عن طريق قراءة قصص المغامرات، مثل جوليس فيرن، إيميلو سالجاري، أو كارل ماي، فأبنائي يعرفون أكثر مما أعرف عن نفس الموضوع من التلفزيون أو الأفلام.
إن جهل هؤلاء الشباب بحادثة “وول ستريت” لم يكن راجعًا فقط إلى عدم التعرف بما يكفي على الكتب، ولكنه يرجع أيضًا إلى نوع من الجهل البصري. فما زال يتم نشر كتب عن أزمة 1929 بشكل منتظم (لابد أن يوجه اللوم لهؤلاء الشباب لعدم ترددهم على المكتبات).
ولا يهتم التلفزيون والسينما بشكل جاء بالأحداث التاريخية. يمكن للمرء أن يعرف قصة الإمبراطورية الرومانية من خلال الأفلام بشرط أن تكون هذه الأفلام صحيحة من الوجهة التاريخية. فالخطأ الذي وقعت فيه هوليود لا يعود إلى عدم وضع أفلامها في مقابل كتب “تاكيتوس” أو “جيبون”، بل لأنها فرضت نسخة شبه رومانسية من كليهما. كانت مشكلة المسئولين عن البورصة حينها أنهم يشاهدون التلفزيون فقط بدلًا من قراءة الكتب، بل إن النشرة العامة كانت المكان الوحيد الذي تم تقديم “جيبون” من خلاله.
واليوم يشتمل مفهوم معرفة القراءة والكتابة العديد من الوسائل الإعلامية والسياسية المستنيرة والتي يجب أخذ إمكاناتها في الاعتبار.
يجب أن يتسع الاهتمام بالتعليم لكل هذه الوسائل. ويجب أن تتوازن كل هذه المسئوليات والمهام، فإذا كانت الشرائط أفضل من الكتب في تعلم اللغات، فيجب أن نهتم بأشرطة التسجيل. وإذا كان تقديم “شوبان” مع تعليق على أقراص مدمجة يساعد الجمهور على فهم “شوبان”، فلا تقلق إذا لم يُقبل الجمهور على شراء سوى خمسة مجلدات من تاريخ الموسيقى، حتى لو كان صحيحًا أن الإعلام المرئي يطغى على الإعلام المكتوب، فالمشكلة ليست وضع الإعلام المرئي في مقابل الإعلام المكتوب، وإنما المشكلة هي كيفية تطوير كليهما. في العصور الوسطى كان الإعلام المرئي للعامة أهم بكثير من الكتابة، لكن كاتدرائية “كارتريس” لم تكن أقل ثقافيًا منImago Mundi of Honorius of Autun[3]. كانت الكاتدرائيات هي أجهزة التلفزيون في هذا العصر، والاختلاف بينها وبين تلفزيون العصر الحديث هو أن مُخرجي العصور الوسطى كانوا يقرؤون كُتبًا جيدة ولديهم الكثير من الخيال ويعملون من أجل الصالح العام (أو على الأقل ما يعتقدون أنه للصالح العام).
الكتب مقابل الوسائل الأخرى
هناك ارتباك حول سؤالين بارزين:
هل سيجعل الكمبيوتر الكتاب شيئًا مهجورًا أو مُهملًا؟
هل سيجعل الكمبيوتر المادة المكتوبة والمطبوعة شيئًا مهجورًا أو مهملًا؟